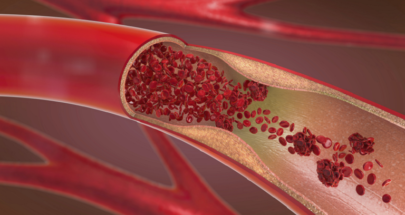متفرقات
هذه قصة المصرفي البريطاني الذي تسبَّب في انهيار المساواة في العالم
الأحد ١٥ أيلول ٢٠١٨ - 13:45

في شهر كانون الثاني من كل عام، وبالتزامن مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس، تكشف منظمة أوكسفام عن حجم نمو ثروة أغنى أغنياء العالم. وفي عام 2016، كشفت التقارير الصادرة عن المنظمة أنَّ أغنى 62 شخصاً تعادل ثروتهم ما يمتلكه النصف الأفقر من سكان العالم. ولكن انخفض العدد هذا العام إلى 42 شخصاً: 42 شخصاً يملكون القدر نفسه الذي يحوزه 3.5 مليار شخص. أصبح هذا الطقس السنوي يشكل جزءاً من دورة الأخبار، لكن ما يفتأ التفاوت الذي تكشف تلك الأخبار يصدمنا. يشكل واقع أنَّ فاحشي الثراء يصبحون أغنى بكثير جزءاً من الحياة الآن، مثله مثل تعاقب المواسم. لكن يجب أن يساورنا قلق بالغ: تمنحهم ثروتهم المتزايدة سيطرة أكبر على سياساتنا ووسائل إعلامنا. تحولت الدول التي كانت في وقت ما دولاً ديمقراطية لتصبح بلوتوقراطية (تخضع لحكم الأثرياء)، والدول البلوتوقراطية أصبحت أوليغارشية (تخضع لحكم الأقلية)، والأوليغارشية أصبحت كليبتوقراطية (أي تخضع لحكم اللصوص). لكن الأمور لم تسر دائماً على هذا النحو. خلال السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، كان هذا التوجه يسير في الاتجاه المعاكس: كان الفقراء يضحون أكثر ثراءً، كنا جميعاً نصبح أكثر مساواة ببعضنا البعض. ولِفهم كيفية تغير ذلك الاتجاه والسبب في ذلك التغير، نحن بحاجة إلى العودة إلى الأيام الأخيرة من الصراع، إلى منتجع في بلدية هامبشاير، حيث اعتزمت مجموعة من الاقتصاديين تأمين مستقبل البشرية. هذه القصة، التي سردتها صحيفة الغارديان، تروي كيف أخفقوا في تحقيق أحلامهم، وكيف نجحت الفكرة العبقرية لمصرفي من لندن في تحطيم العالم.
في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، تدفَّقت الأموال بين البلدان بصورة كبيرة وفقاً لرغبة أصحابها، مما أدى إلى زعزعة استقرار العملات والاقتصادات، سعياً وراء الربح. وبالرغم من تهاوي الاقتصادات، فقد أصبح العديد ممن كانوا أغنياء أكثر ثراءً. أدت الفوضى إلى انتخاب الحكومات المتطرفة في ألمانيا وفي مناطق أخرى، وإلى جانب التنافس على خفض قيمة العملة وسياسات إفقار الجار، وتجارة الحروب، وفي نهاية المطاف قادت إلى أهوال الحرب العالمية الثانية. أراد الحلفاء منع تكرار ذلك إلى الأبد، لذا في اجتماع عُقد في منتجع بريتون وودز في ولاية نيوهامبشير عام 1944، تفاوضوا على تفاصيل الهندسة الاقتصادية التي من شأنها وقف تدفقات الأموال غير الخاضعة للتحكم إلى الأبد. أجروا تلك المفاوضات آملين أن هذا قد يمنع الحكومات من استخدام التجارة كسلاح للتنمر على الجيران، وتأسيس نظام مستقر من شأنه أن يساعد في تأمين السلام والازدهار. وبموجب النظام الجديد، سيجري ربط جميع العملات بالدولار الذي بدوره مرتبط بسعر الذهب. تساوي أونصة (31.1 غرام) الذهب 35 دولاراً أميركياً (أي ما يعادل 500 دولار/394 جنيه إسترليني في يومنا هذا). وبعبارة أخرى، تعهّدت وزارة الخزانة الأميركية، أنَّه إذا أتت حكومة أجنبية وبحوزتها 35 دولاراً يمكنها دائماً شراء أونصة ذهب. كانت الولايات المتحدة تتعهد بتزويد كل شخص بما يكفي من الدولارات لتمويل التجارة الدولية، إلى جانب الحفاظ على احتياطي كاف من الذهب من أجل تلك الدولارات لتكون ذات قيمة في الأساس. لإيقاف محاولات المضاربين التجاريين لمهاجمة تلك العملات ذات سعر الصرف الثابت، خضعت عملية تدفقات المال عبر الحدود لقيود شديدة. يمكن نقل المال عبر البحار، ولكن فقط في صورة استثمارات طويلة الأجل، وليس للمضاربة قصيرة الأمد لإضعاف العملات أو السندات المالية. لفهم طريقة عمل ذلك النظام، تخيل ناقلة النفط. إذا كان لديها خزان ضخم واحد فقط، يمكن إذاً أن يترنح النفط يميناً ويساراً عند التعرض للموجات التي تكون أشد من أي وقتٍ مضى، حتى يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار السفينة، التي بدورها تنقلب وتغرق. أثناء مؤتمر بريتون وودز، وُزع النفط على خزانات أصغر وكل بلدة تملك واحداً. وبذلك يمكن للنفط السائل أن يترنح داخل خزاناته الصغيرة، ولكن في المقابل لا يمكنه التسبب في حركة كبيرة تؤدي بدورها للإضرار بسلامة السفينة.
من الغريب أنَّ من أفضل ما استدعى من الماضي ذلك النظام الذي انقضى منذ زمن بعيد هو كتاب Goldfinger، الجزء السابع من سلسلة جيمس بوند. يحتوي الفيلم الذي يحمل نفس الاسم على حبكة مختلفة قليلاً، ولكن كلاهما يعرضان محاولة ترمي إلى تقويض النظام المالي الغربي، عن طريق التدخل في احتياطات الذهب الخاصة به. شرح مسؤول ببنك إنكلترا، وهو العقيد سميثرز/Colonel Smithers إلى العميل جيمس بوند المعروف باسم «العميل 007″، كيف أنَّ «الذهب والعملات المدعومة به يشكلان أساس ائتماننا الدولي». ويكمل سميثرز كلامه قائلاً، إنَّ المشكلة تكمن في أنَّ البنك على استعداد لدفع ألف جنيه إسترليني (1291.3 دولار تقريباً) فقط مقابل قالب الذهب، وهو ما يعادل 35 دولاراً لسعر أونصة الذهب المدفوعة في أميركا، ولكن يزيد سعر عيار الذهب نفسه بنسبة 70% في الهند، حيث يرتفع الطلب هناك على المجوهرات الذهبية. وبالتالي فإنَّه من المربح للغاية تهريب الذهب من البلاد وبيعه في الخارج. يتمثل المخطط الماكر لأوريك غولد فينغر الشرير في امتلاك جميع المسترهنين في جميع أنحاء بريطانيا، وشراء المجوهرات والحلي الذهبية من البريطانيين العاديين، الذين يحتاجون إلى القليل من السيولة، ثم إذابة الذهب إلى قوالب، ووضعها في سيارته الرولز رويس، ثم نقلها إلى سويسرا، وإعادة معالجته ونقله إلى الهند. وعن طريق ذلك، لن يقتصر ما يفعله غولد فينغر على تقويض الاقتصاد والعملة البريطانية فقط، بل سيجني من ورائه الأرباح التي يُمكنه استخدامها في تمويل الشيوعيين وغيرهم من المجرمين. يشارك مئات من موظفي بنك إنكلترا في محاولة لمنع وقوع هذا النوع من النصب، ولكن غولد فينغر أدهى منهم، حسبما أخبر سميثرز العميل 007. وقد أصبح أغنى رجل في بريطانياً سراً، ولديه ثروة من قوالب الذهب تساوي 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.5 مليار دولار أميركي) موجودة في خزائن مصرف في جزر البهاما. يقول سميثرز: «نحن نطلب منك يا بوند إحضار غولد فينغر لمعاقبته واستعادة ذلك الذهب. هل تعلم بشأن أزمة العملة وارتفاع سعر البنك؟ بالطبع. حسناً، إنكلترا بحاجة ماسة إلى هذا الذهب وكلما أسرعت كان ذلك أفضل». في إطار المعايير الحديثة، لم يرتكب غولد فينغر أي خطأ، ربما باستثناء التهرب من بعض الضرائب. كان يستأثر بكل الذهب بسعر كان الناس على استعداد لدفعه نظير الذهب، ثم يبيعه في سوق أخرى بسعر أعلى حيث يوجد أناس على استعداد لشرائه بهذا الثمن المرتفع. كان الذهب ملكه. لذا أين هي المشكلة؟ كان يساعد على تسهيل التجارة بنجاح ودون مشاكل، وتخصيص رأس المال بكفاءة، حيث يمكن استخدامه على أفضل وجه، لِمَ لا؟ في الحقيقة كانت هناك مشكلة، لأن تلك الطريقة لم تكن ما خلص إليه مؤتمر بريتون وودز. اعتبر سميثرز أنَّ الذهب ليس ملكاً لغولد فينغر فقط، بل لبريطانيا العظمى أيضاً. لا ينظر النظام إلى مالك المال على أنَّه الشخص الوحيد المسؤول عن تحديد وجهة المال. ووفقاً للقواعد التي أرسيت بعناية، فإنَّ الدول التي حدّدت قيمة المال وضمنتها تتمتع بحقوق في ذلك المال أيضاً. قيّدت الدول حقوق أصحاب المال من أجل مصلحة الجميع. وخلال مؤتمر بريتون وودز، قرر الحلفاء، الذين يئسوا من تجنب تكرار فظائع الكساد الاقتصادي فيما بين الحربين والحرب العالمية الثانية، أنَّه عندما يمس الأمر التجارة الدولية، فحقوق المجتمع تتفوق على حقوق أصحاب المال.
يصعب تخيل كل هذا على أي ممن عاصر هذا النظام فقط منذ الثمانينات، لأنَّ النظام مختلف الآن كثيراً. يتدفق المال دون توقف بين البلدان، مفسحاً المجال لفرص الاستثمار في الصين والبرازيل وروسيا أو أي مكان كان. وفي حال ما إذا زادت قيمة العملة بصورة مبالغ فيها، يشعر المستثمرون بالضعف أمامها ويلتفون حولها مثل التفاف أسماك القرش حول حوت واهن. في أوقات أي أزمة عالمية، يتراجع المال أمام أمان الذهب وسندات الحكومة الأميركية. وفي أوقات الازدهار، يرفع المال أسعار الأسهم إلى مستوى آخر في مسعاه المضطرب لتحقيق عائد جيد. تلك الزيادة في رأس المال السائل تتمتع بقوة من شأنها أن تزيح كل ما أمامها باستثناء الحكومات الأقوى. كانت الهجمات المتضاربة المطولة على اليورو أو الروبل أو الجنيه، التي كانت السمة المميزة للعقود القليلة الماضية، مستحيلة في ظل نظام بريتون وودز الذي صمم خصيصاً لمنع حدوثها. حقق النظام نجاحاً بشكل ملحوظ: لم يواجه النمو الاقتصادي في معظم الدول الغربية أي عراقيل على مدار الخمسينات والستينات، وأصبحت المجتمعات أكثر مساواة، في حين حققت الحكومة تقدماً هائلاً في مجال الصحة العامة والبنية التحتية. ولم يكن ثمن كل ذلك زهيداً. إذ كان لا بد من أن تكون الضرائب مرتفعة لتعويض النفقات، وكافح الأغنياء لنقل أموالهم بعيداً عن قبضة رجال الضرائب، والفضل يعود إلى الخزانات المنفصلة في ناقلات النفط. يتذكر جمهور فرقة البيتلز جورج هاريسون حين كان يغني Taxman تلك الأغنية التي دارت حول تحصيل الحكومة 19 شلناً على كل شيء يمكن أن تفرض عليه ضريبة، وكان ذلك انعكاساً دقيقاً لمقدار الأموال التي كانت تذهب إلى وزارة الخزانة من أرباحه، وكان معدل الضريبة يساوي 95%. لم تكن فرقة البيتلز وحدها تسبب الكراهية لهذا النظام، بل أيضاً فرقة الرولينغ ستونز، التي انتقلت إلى فرنسا لتسجيل ألبوم Exile في شارع الإليزيه بفرنسا. وكذلك رولاند بارينغ، وهو سليل عائلة بارينغ المالكة لبنك Barings bank، وثالث إيرل في عائلة كرومر، بين عامي 1961 و1966، وهو محافظ مصرف إنكلترا. وكتب في مذكرة إلى الحكومة عام 1963: «يُعد مراقبة التبادل انتهاكاً لحقوق المواطن. لذا، فأنا أعد ذلك خطأً من الناحية الأخلاقية». سبب واحد هو ما دفع بارينغ إلى كراهية القيود، هو أنَّها كانت تقتل في مدينة لندن التي هي جزء من العاصمة لندن. رثى مصرفي الفترة التي قضاها في رئاسة أحد البنوك البريطانية الكبرى قائلاً: «كان الأمر أشبه بقيادة سيارة قوية بسرعة 20 ميلاً في الساعة. كانت البنوك تحت التخدير. وكان ذلك نوعاً من الحياة الخيالية». في تلك الأيام كان المصرفيون يصلون إلى العمل في وقت متأخر ويغادرون مبكراً، وكانوا يضيعون معظم الوقت في تناول وجبات الغداء التي كانت لا تخلو من تناول المشروبات الكحولية حتى الثمالة. لم يهتم أحد بشكل خاص، لأنَّه لم يكن هناك الكثير من العمل للاضطلاع به على أي حال. اليوم، عند النظر إلى أفق المدينة المليء بالمباني الزجاجية والفولاذية، من الصعب تخيل أن مدينة لندن كانت على وشك الفناء في يومٍ ما كمركز مالي. في الخمسينات والستينات لعبت المدينة دوراً صغيراً في المحادثات الوطنية. ومع ذلك، بالرغم من أنَّ القليل من الكتب حول فترة الستينات المضطربة ذكرت المدينة، فشيء مهم للغاية كان يلوح في الآفاق، شيء من شأنه تغيير العالم أكثر بكثير مما فعلت فرقة البيتلز أو مصممة الأزياء ماري كوانت أو ديفيد هوكني، شيء من شأنه تحطيم القيود الصارمة التي وضعها نظام بريتون وودز.
بحلول الوقت الذي نشر فيه إيان فليمنغ كتاب Goldfinger عام 1959، كان هناك بالفعل بعض التسريبات في خزانات النفط. كانت المشكلة هي أنَّ ليس كل الحكومات الأجنبية وثقت في الولايات المتحدة في الوفاء بالتزامها باستخدام الدولار كعملة دولية محايدة، وكانوا عقلاء في هذا الأمر نظراً لأن واشنطن لم تعمل دائماً كحكم عادل. في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة، صادرت الحكومة الأميركية احتياطي الذهب من يوغوسلافيا الشيوعية. بعد ذلك اعتادت الدول المتعثرة للكتلة الغربية على الحفاظ على دولاراتها في البنوك الأوروبية بدلاً من نيويورك. وعلى نحو مماثل، عندما حاولت فرنسا وبريطانيا استعادة السيطرة على قناة السويس عام 1956، جمّدت واشنطن الرافضة لمسعاهما وصولهم إلى الدولارات وحكمت على مشروعهم بالفشل. لم تكن تلك تصرفات حكم محايد. كانت بريطانيا في ذلك الوقت تتخبط بين أزمة وأخرى. وفي عام 1957، رفعت أسعار الفائدة ومنعت البنوك من استخدام الجنيه الإسترليني لتمويل التجارة في محاولة للحفاظ على قوة الجنيه (كانت تلك «أزمة العملة ومعدل الخصم الرسمي المرتفع للبنك» الذي أخبر سميثرز بوند بشأنه).
بدأت بنوك مدينة لندن، التي لم تعد تستخدم الجنيه الإسترليني بنفس الطريقة التي اعتادتها في استخدام الدولار بدلاً من ذلك، وحصلت على تلك الدولارات من الاتحاد السوفيتي، الذي كان يُبقي عليها في لندن وباريس بهدف تجنب التعرض للضغط الأميركي. واتضح أن التعامل بالدولارات يدر أرباحاً. ففي الولايات المتحدة، كانت هناك قيود على مقدار الفائدة التي يمكن أن تفرضها البنوك على القروض بالدولار، ولكن لم ينطبق الأمر على لندن. أعاد هذا السوق، الذي أطلق المصرفيون فيه على الدولار «دولارات أوروبية»، الحياة قليلاً إلى مدينة لندن الصغرى في أواخر الخمسينيات، ولكن ليس بقدر كبير. كانت المشاكل المتعلقة بالسندات لا تزال قائمة في نيويورك، وهي حقيقة أزعجت العديد من المصرفيين في لندن. بعد كل شيء، كانت العديد من الشركات التي تقترض المال أوروبية، بالرغم من أن البنوك الأميركية كان لها نصيب الأسد من العمولات. لم يكن مصرفيّ واحد على وجه التحديد مستعداً لتحمل ذلك: سيغموند فاربورغ. كان فاربورغ غريباً في العالم الودود لمدينة لندن، كان ألماني الجنسية. وبالنسبة لأشخاص آخرين، لم يتخل عن فكرة أن مَهمة أحد مديري البنك هي بذل جهود قوية في العمل. في عام 1962، تعلم فاربورغ من صديق له في البنك الدولي أن نحو 3 مليارات دولار أميركي تدور خارج الولايات المتحدة، تطوف في البلاد وهي جاهزة لاستغلالها. عمل فاربورغ كمصرفي في ألمانيا في العشرينيات وتذكر الترتيب لإبرام صفقات سندات بالعملات الأجنبية. لماذا لم يستطع المصرفيون لديه فعل شيء مماثل من جديد؟ حتى تلك اللحظة، إذا أرادت شركة ما اقتراض دولارات، كان عليها الاقتراض في نيويورك. ومع ذلك كان فاربورغ واثقاً للغاية من أنَّه عرف أين يعثر على جزء كبير من الثلاثة مليارات دولار، إلى أن قاده الأمر إلى سويسرا. منذ عشرينات القرن العشرين على الأقل، كان السويسريون يعملون في مجال اكتناز الأموال والأصول نيابة عن الأجانب الذين أرادوا تجنب التدقيق. وبحلول عام 1960، أصبح نحو 5% من كل المال في أوروبا مخبأ أسفل المراتب الفولاذية في سويسرا. بالنسبة لأكثر الممولين طموحاً في مدينة لندن الصغرى، كان هذا محيراً، إذ وضع كل هذا المال بعيداً، دون سبب تقريباً، وكان بالضبط هو القدر الذي احتاجوه في مسعاهم للبدء في بيع السندات مجدداً. رأى فاربورغ أنَّه إذا كان باستطاعته بشكل ما الوصول للمال، وجمعه وتسليفه، سيزاول العمل. وبالطبع فكر فاربورغ: أليس باستطاعته إقناع الأشخاص الذين كانوا يدفعون للمصرفيين السويسريين للاهتمام بأموالهم أن بإمكانهم جني دخل منه بشراء سنداته؟ وأليس بإمكانه بلا شك إقناع الشركات الأوروبية أن استعارة المال منه أفضل لهم ليتجنبوا دفع المصروفات الباهظة المطلوبة في نيويورك؟ كانت فكرة جيدة، لكن كانت هناك مشكلة، الخزانات المستقلة لناقلات النفط كانت في طريقها، ويستحيل على فاربورغ أن ينقل هذا المال من سويسرا عبر لندن للعملاء الراغبين في استعارته. لكنه طلب من اثنين من أفضل رجاله إتمام الأمر على أية حال. بدأوا جهودهم في أكتوبر/تشرين الأول 1962، في الشهر نفسه الذي أطلقت فيه فرقة البيتلز أغنية Love Me Do. استكمل المصرفيون اتفاقهم في الأول من يوليو/تموز في العام الذي يليله، في اليوم نفسه الذي سجل فيه فريق فاب فور أغنية She Loves You، تلك الأغنية التي غنتها أولاً فرقة بيتلز، وجعلت الجميع مهوسين بالفرقة. لم تحدث هذه الأشهر التسعة الاستثنائية ثورة في موسيقى البوب فقط، لكن أيضاً في الجغرافيا السياسية، بما أنَّها تضمنت أزمة الصواريخ الكوبية، وخطاب «Ich bin ein Berliner» أو «أنا برليني» لجون كينيدي. في ظل هذه الظروف، من المفهوم أن ثورة متزامنة في التمويل العالمي مرَّت كأن لم تكن. قاد المشكلة الجديدة الخاصة بسندات فاربورغ -تلك السندات التي أصبحت تعرف بالسندات الأوروبية، عقب استخدام مصطلح الدولارات الأوروبية- إيان فريزر، بطل الحرب الاسكتلندي الذي تحول لصحافي ثم مصرفي. اضطر هو وزميله بيتر سبيرا إلى إيجاد طرق لكسر شوكة الضرائب والقيود المصممة لمنع تدفق أموال المضاربة بين الحدود، ولإيجاد طرق لانتقاء واختيار جوانب مختلفة للوائح من دول مختلفة لخدمة عناصر متعددة لما كانا يُعدانه. في حال أُصدرت السندات في بريطانيا، سيُفرض عليها ضرائب بنسبة 4%، لذا أصدرها فريزر في مطار سخيبول بأمستردام. إذا كانت الفائدة ستُدفع في بريطانيا، كانت لتجذب ضريبة أخرى، لهذا رتب فريزر لدفعها في لوكسمبورغ. ونجح في إقناع بورصة لندن بإدراج السندات رغم أنَّها سندات لم تصدر أو تستهلك في بريطانيا، وتجنب الحديث عن هذا مع البنوك المركزية في فرنسا، وهولندا، والسويد، والدنمارك، وبريطانيا، وجميعها كانت تشعر بقلق لسبب وجيه بخصوص تأثير سندات اليورو على ضوابط العملات. كانت الخدعة الأخيرة هي التظاهر بأنَّ المقترض هو Autostrade -شركة الطرق السريعة الإيطالية- بينما كان في الحقيقة شركة International Registries، وهي شركة قابضة حكومية. لو كانت شركة International Registries هي المقترض، كان عليها خصم الضريبة من المنبع، أما شركة Autostrade لم تكن مضطرة لذلك. كان الأثر التراكمي لهذه اللعبة من التهرب من الإلزامات القضائية أنَّ فريزر صنع سنداً يحقق معدل فائدة جيداً، لا يضطر فيها أي شخص لدفع ضريبة من أي نوع، ويمكن إعادتها لسيولة مالية في أي مكان. عُرفت تلك السندات باسم «سندات لحاملها». من يتحكم بالسندات يملكها، لم يكن هناك تسجيل ملكية أو أي إلزام يسجل ملكيتك التي لم تكن مسجلة أصلاً في أي مكان. كانت سندات فريزر كالسحر. قبل السندات الأوروبية لفريزر، لم يكن بالإمكان استغلال الثروة المخبأة في هولندا لفعل الكثير، لكن الآن صار بإمكانها شراء هذه الورقة المبهرة التي يمكن حملها في أي مكان ومعاودة شرائها في أي مكان، وتدفع الفائدة كلها لصاحبها بلا أي ضرائب. إذن من كان يشتري اختراع فريزر المذهل؟ من كان يقدم المال الذي كان يعيره فريزر لشركة international registries عن طريق شركة Autostrade؟ كتب فريزر في مذكراته أنَّ «المشترين الأساسيين لهذه السندات كانوا أفراداً من أوروبا الشرقية عادة، لكنهم غالباً أيضاً كانوا أفراداً من أميركا اللاتينية أرادوا تحويل جزء من ثروتهم لتكون في صورة يسهل نقلها، وهكذا إذا اضطروا للمغادرة يمكنهم المغادرة بسرعة مع سنداتهم في حقيبة صغيرة، مضيفاً: «كانت الهجرة الجماعية للسكان اليهود الناجين في وسط أوروبا إلى إسرائيل والغرب لا تزال مستمرة. وأضيف لهذا هجرة الحُكام الدكتاتوريين الذين أُطيحوا في أميركا الجنوبية إلى الشرق. كانت سويسرا هي المكان الذي أُخفي فيه كل هذا المال». وفي وقت لاحق، حاول المؤرخون التقليل من قدر فريزر، وزعم أنَّ السياسيين الفاسدين -الحُكام الدكتاتوريون الذين سقطوا في أميركا الجنوبية- شكلوا خُمس أولى طلبات إصدار هذه السندات أو ما يقارب هذا. وبالنسبة للأربعة أخماس الباقية من الأموال التي اشترت بها السندات، فقد جاءت من المتهربين من الضرائب القياسية، الذين سماهم المصرفيون «أطباء الأسنان البلجيكيين» أي المهنيين أصحاب الكسب العالي الذين نقلوا جزءاً من مكاسبهم إلى لوكسمبورغ أو جينيف، ورحبوا بهذا الاستثمار الظريف الجديد. أطلقت السندات الأوروبية حرية الثروة وكانت الخطوة الأولى تجاه التأسيس للدولة الافتراضية للأغنياء، التي أطلق عليها اسم «أرض المال/Moneyland». تضمنت أرض المال أموالاً خارجية، لكنها أشمل من هذا بكثير، إذ تحمي كل جوانب حياة الشخص الغني من عملية التدقيق، لا أمواله فقط. وطريقة جني المال التي غوت فريزر لكسر قيود العاصمة نيابة عن عملائه، هي نفسها تلك التي أغرت نظراءه في العصر الحديث لإيجاد طرق لأغنى الناس في العالم لتجنب ضوابط التأشيرات، والتدقيق الصحافي، والمسؤولية القانونية، وأكثر من هذا بكثير. أرض المال هي مكان لا يطبق فيه القانون عليك إذا كنت غنياً كفاية، أياً ما كنت، وأينما كان مصدر مالك.
هذا هو السر الدنيء الذي كان محور إعادة ميلاد مدينة لندن، وبداية العملية التي قادت في النهاية إلى التفاوت الحالي بين الطبقات. صار كله ممكناً بوسائل الاتصال الحديثة مثل التليغرام، والهاتف، والتلكس، والفاكس، والبريد الإلكتروني، ومكن أغنى الناس في العالم من تجنب مسؤوليات المواطنة. كانت الصفقة الأولى بقيمة 15 مليون دولار، لكن بمجرد التعرف على طريقة تجنب العقبات التي أوقفت تدفق المال الخارجي، لم يكن هناك أي شيء يمكنه إيقاف تدفق المزيد من المال بعد ذلك. في النصف الثاني من عام 1963، بيع 35 مليون دولار من السندات الأوروبية. وفي عام 1964 بلغ التداول في سوق السندات تلك 510 ملايين دولار. أما في عام 1967، فقد تجاوزت السندات المليار دولار للمرة الأولى، وهي الآن واحدة من أكبر الأسواق في العالم. كانت النتيجة بمرور الوقت، هي انهيار النظام الذي وضع في بريتون وودز. كان المزيد من الدولارات تهرب للخارج، حيث يُمكن تجنب القوانين والضرائب التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، لكنها تبقى دولارات، وبالتالي لا تزال كل 35 منها تساوي أونصة من الذهب. نبعت المشكلة اللاحقة من حقيقة أنَّ الدولارات لم تكن بلا عمل، بل تضاعفت. إذا وضعت دولاراً في بنك، يستخدمه البنك كضمان للمال الذي يقرضه لشخص آخر، مما يعني أنَّ هناك المزيد من الدولارات، دولاراتك ودولارات الشخص الآخر الذي اقترضها. ولو وضع هذا الشخص المال في بنك آخر، ثم أعارها البنك، ستكون هناك دولارات أكثر، وهكذا تستمر العملية. وبما أن كل دولار من هذه الدولارات يساوي شكلياً كمية ثابتة من الذهب، كانت الولايات المتحدة الأميركية ستحتاج لشراء المزيد من الذهب لتلبية الطلب المحتمل عليه. لو فعلت الولايات المتحدة هذا، كانت لتشتري هذا الذهب بالدولارات، مما يعني وجود المزيد من الدولارات التي ستتضاعف بدورها، فيزيد شراء الذهب، وتزيد الدولارات حتى ينهار النظام في النهاية تحت وطأة حقيقة أنه غير منطقي، عجز عن التعامل مع الخارج. حاولت الحكومة الأميركية تحديد سعر الدولار المرتبط بالذهب لكن كل تقييد وضعته على حركة الدولار رفع ربح الاحتفاظ بدولاراتك في لندن، مما أدى إلى تسرب المزيد من المال للخارج، وبالتالي بناء المزيد من الضغط على سعر الدولار المرتبط بالذهب. أينما ذهبت الدولارات، تبعها المصرفيون. كان لمدينة لندن قواعد أكثر مرونة، وسياسيون أكثر استيعاباً من بورصة وول ستريت، وقد أحب المصرفيون تلك القواعد، عام 1964، امتلك 11 بنكاً أميركياً فروعاً له في مدينة لندن، وعام 1975، أصبحوا 58 فرعاً. فَتَح المكتب الأميركي لمراقبة العملة، الذي أدار النظام المصرفي الفيدرالي، مكتباً دائماً في لندن لتقصي ما تفعله البنوك الأميركية، لكن الأميركيين كانوا بلا سلطة في بريطانيا، ولم يحصلوا على مساعدة من المحليين. وقال جيم كيو، وهو مسؤول ببنك إنكلترا معني بمراقبة هذه البنوك: «لم يكن يهمني ما إذا كان Citibank يتهرب من اللوائح الأميركية في لندن».
بحلول ذلك الوقت، رضخت واشنطن للأمر الواقع، وتوقفت عن الوعد باستبدال الدولارات بالذهب بسعر 35 دولاراً للأونصة. كانت هذه هي الخطوة الأولى في التفكك المتواصل لكل الضمانات التي وضعت في بريتون وودز. وأجيب عن التساؤل الفلسفي بشأن من يملك المال حقاً، الشخص الذي ربحه أم الدولة التي صنعته. لو كنت تملك المال، يمكنك بفضل المصرفيين في لندن وسويسرا أن تفعل به ما تشاء، ولا تستطيع الحكومات منعك. طالما أنَّ دولة واحدة تسامحت مع المؤسسات الخارجية كما فعلت بريطانيا، فستذهب جهود كل الدول الأخرى هباءً. إذا كانت اللوائح تتوقف عند حدود الدول، بينما يمكن للمال أن يتدفق أينما شاء، يمكن إذن لمالكيه تجاوز أي جهات تنظيم يختارونها.
لم تتوقف التطورات التي بدأت عند فاربورغ بالتوصل لسندات اليورو البسيطة. النمط الأساسي يمكن تكراره بلا نهاية لإيجاد خط تجارة يدر عليك وعلى عملائك المال. ابحث في العالم عن ولاية بها نظام قضائي تكون قوانينه ملائمة لهذه التجارة (مثل ليختنشتاين، وجزر كوك، وجيرسي) واستخدم الولاية قاعدة أساسية. إذا عجزت عن إيجاد ولاية بها القوانين الملائمة، أنت إذن مهدَّد، أو مغر للآخرين للتودود إليك حتى تغير قوانينها لتناسبك. بدأ فاربورغ نفسه هذا حين شرح لبنك إنكلترا أنَّ بريطانيا إذا لم تجعل قوانينها تنافسية وضرائبها أقل، سيأخذ بنكه لمكان آخر، ربما إلى لوكسمبورغ. بسهولة وسرعة، تغيرت القوانين، وألغيت الضرائب، وفي هذه الحالة، كانت الضرائب هي رسوم الدمغة المفروضة على حاملي السندات. رد فعل العالم على هذه التطورات كان متوقعاً بالكامل. بمرور الوقت، كانت الدول تسارع لمواكبة التجارة التي خسرتها لصالح المؤسسات الخارجية (كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية بإلغاء اللوائح التي كانت البنوك تتهرب منها بالانتقال إلى لندن)، وبالتالي جعل عالم المؤسسات الداخلية أكثر شبهاً بممارسات عالم المؤسسات الخارجية الذي خلقه مصرفيو فاربورغ. أُسقطت الضرائب، وخُففت القيود، وأصبح السياسيون أكثر وداً، وهذا كله محاولة لإغراء المال الهائج ليستقر في ولاية واحدة بدلاً من الأخرى. سبب هذا بسيط، فمبجرد أن تسمح لك السلطة القضائية بالقيام بما تريده، تتدفق الأعمال التجارية هناك، وتسارع السلطات القضائية الأخرى لتتغير أيضاً. هذا هو التصعيد الذي تسببه أرض المال، خسارة اللوائح دائماً لصالح تربُّح هؤلاء الذين يملكون المال، وعدم تقييدهم أبداً. تأثرت أمم مختلفة بأرض المال بطرق عدة. امتلك المواطنون الأغنياء في دول أوروبا وأميركا الجنوبية أكبر قدر من المال النقدي الخارجي، لكنها نسبة صغيرة نسبياً من ثروتهم القومية، بفضل حجم اقتصادهم الكبير. قدر الاقتصادي غابرييل زوكمان حجم أموالهم في الخارج بأنه يمثل 4% فقط من ذلك الخاص بأميركا. أما روسيا فيوجد 52% من ثرواتها الداخلية في الخارج، بعيداً عن متناول الحكومة. وفي دول الخليج سجلت نسبة صادمة بلغت 57%. يقول زوكمان: «من السهل على حكومات الدول النامية والدول غير الديمقراطية إخفاء ثرواتهم. فهذا يوفر لهم حوافز ضخمة لنهب دولهم، ولا يوجد رقيب». في يناير/كانون الثاني المقبل، سنحصل على تحديث عن كمية الثروة التي أخذتها هذه الحكومات من العالم لنفسها، والمفاجأة الوحيدة ستكون الحجم الدقيق لاستحواذهم الجديد، وقلة ما تركوه لبقيتنا. لكن لا ينبغي أن ننتظر لذلك الحين حتى ندرك الطبيعة الملحة للوضع. علينا التصرف الآن، وتسليط الضوء على ثروتهم، وعلى القضية المظلمة التي تُضعف قوتها التثاقلية نسيج مجتمعاتنا. ربما كنا نتجاهل أرض المال، لكن مواطنيها الهائمين في العالم لا يتجاهلونها. إذا كنا نرغب في استعادة السيطرة على اقتصادنا، وديمقراطيتنا، علينا التصرف الآن. كل يوم ننتظره، يتكدس المزيد من المال ضدنا.
(عربي بوست)